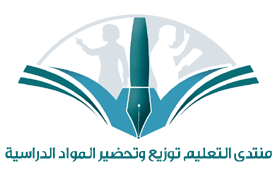|
|||||||
| الركن العام للمواضيع العامة يهتم بالمواضيع العامه ومناقشتها كما هو متنفس لجميع الأعضاء والزوار |

|
|
|
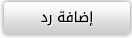 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
[11] |
|
عضو فضي
 |
3- (الفكر) يصبح أكثر تأثيراً وأشدّ فاعلية عندما يلتصق بشخصية ثرية علمياً...وقادرة خلقياً على ترك بصمات في وجدان المخاطَبين، ونفسيات المتلقّين. وكذلك كان الفيزيائي الفذ والمفكر المرموق البروفسور محجوب عبيد طه، فقد كان من الصعب على من عرفه وتعامل معه أن يفصل بين محجوب (الإنسان)، ومحجوب (المفكر)، ومحجوب (العالم). لقد كانت تلك المحاور الثلاثة تتمركز بحيوية حول شخصية ذلك الرجل النحيل الذي يأسرك - بادئ ذي بدء - بخلق رفيع ينطلق من الذات دون تكلّف، ويجذبك بتواضع أصيل لا تصنّع فيه، ثم إذا عرّجت معه على ساحات (الفكر العلمي) وفلسفته وتفاعلاته وجدت قمة شامخة تأبى إلا أن تساعدك بكل طريقة للصعود إلى بعض مشارفها. أما إذا دفعك الفضول لمتابعة شخصية هذا الرجل فسألت أهل الاختصاص -شرقاً أو غرباً - عن إسهاماته العلمية في مجال (الفيزياء النظرية) و(فيزياء الكون)، لجاءك الخبر اليقين عن قدرة ذهنية فذة في مجال (الرياضيات) التحمت مع فهم عميق لقضايا (الفيزياء)، وعطاء متدفق في ربوعها. من منطلقات محجوب الفكرية حرصه البالغ على إبراز (إنسانية) المنهج العلمي الذي طبّقت شهرته الآفاق، وأصبحت آثاره تمتد إلى كل ركن من أركان المعمورة، وتؤثر على كل منحى من مناحي الحياة. ذلك التفوق الباهر قاد إلى تصوّر يجعل معطيات (المنهج العلمي) مسلّمات خارجة عن نطاق تصورات الباحث وقناعاته وتحيزاته. ولكن محجوب يحرص على تفكيك أسس التحليل في (المنهج العلمي) وضبط أدواته للفصل بين (الحقائق والثوابت) في المنهج العلمي، وبـين (العقيدة) التي يحملها الباحث، ويفرض عبرها قناعاته الفردية على نتائج ومعطيات ذلك المنهج. لا شك عندي في أن شخصية محجوب المعجونة في التواضع العفوي، والغارقة في الزهد التلقائي، كان لها الأثر الأكبر على (فكره) فانطلق، بعد التمكّن من معطيات ذلك المنهج والتفوّق في أدواته، إلى تشخيصه وتمحيصه ومحاكمته من الداخل لينزل به من تلك المرتبة العليا التي بلغت (درجة التقديس) عند كثير من العلماء الطبيعيين، وانتشرت كالنار في الهشيم في (الثقافة الإنسانية المعاصرة). لم يكن ذلك (الموقف الانبهاري) ليتفق مع طبيعة محجوب وتصوّره العقدي وفهمه لخصائص الكون وطبائع البشر، ولذا فإنه اهتم بإبراز عورات (المنهج) و(إنسانيته)، ولذا كنت أقول له إنك أيضاً باتخاذ هذا المنحى تعكس في الواقع تركيبتك الشخصية وقناعاتك الفردية، وبالرغم من بعض التحفظات التي كنت أخوض معه فيها إلا أننا - في نهاية المطاف - ينبغي أن ندرك قوة المنطق وعمق الحجة في تحليل محجوب وتشريحه للمنهج العلمي – التجريبي. فـي تبريره وتفسيره لذلك الحرص على الفصل بين (الحقائق) و(العقائد) في (المنهج العلمي)، يقول محجوب – رحمه الله -: (ما يدفعني إلى الاهتمام بهذا الموضوع هو ملاحظتي أن كثيراً من المثقفين والعلميين يعتقدون بوجود اختلاف جوهري، أي اختلاف نوع لا اختلاف درجة، بين ماهية البرهان في العلم الطبيعي من ناحية، وفي كافة اهتمامات الناس الاجتماعية والسياسية والعقائدية من ناحية أخرى. هذا ليس صحيحاً، ولنأخذ الدوريات العلمية والصحف السيارة. المجتمع العلمي يُلزم العاملين فيه بتقاليد صارمة للنشر، منها إخضاع العمل للتقويم والتحكيم قبل نشره، ولذلك فإن ما يُنشر يمثل في الغالب مجهوداً عُـبّر عن محتواه ودلالته وأهميته تعبيراً أميناً، بُني على التدقيق والتمحيص والنظر في الأعمال السابقة ذات الصلة بموضوعه. وبسبب أن المجتمع الصحفي لم ينجح في إلزام العاملين فيه بمثل هذه الضوابط، نجد أن كثيراً مما تنشره الصحف السيارة يفتقر إلى الدقة والأمانة والإنصاف، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن وجهة نظر فردية قد لا تخلو من الغرض والظن). بعد إقرار تلك الفروق بين (النشر العلمي) و(النشر الصحفي) التي تبدو وكأنها مدخل إلى إبراز (تمييز نوعي) بين مجالين مختلفين، فإن محجوب يفاجئنا ليقول: (غير أن هذا الاختلاف بين ضوابط النشر في الدوريات المحكمة وفي الصحف السيارة لا يشكّل اختلافاً في ماهية البرهان في المجالين. البرهان المطلوب في الحالين هو ما تحصل به القناعة. وكثير من علماء الاجتماع يبنون تحليلاتهم على معلومات دقيقة وتقارير مفصّلة، حُـصّلت بعد عمل مضن، ويتوصّلون إلى أراء وملاحظات محايدة وأمينة ينشرونها في دوريات محكمة. مثل هذه الأعمال طابعها الجدية والحرص والتأني، ولا يكاد بفصلها عن بحوث العلوم الطبيعية إلا اختلاف الموضوع إذ لا يتاح في علم الاجتماع ما يتاح في العلم التجريبي من تجزئة النظام، وفصل المتغيرات، وتكرار التجريب، وإزالة آثار البيئة وضوضائها). وهكذا يضع محجوب إصبعه على الفارق الرئيس بين ماهية (البرهان) في (العلم الطبيعي) وماهيته في (العلوم الإنسانية)، ويقول: (بسبب هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع لم تتمكّن العلوم الإنسانية، مثل علم الاجتماع وعلم السياسة، من تحقيق التطوّر المذهل الذي تحقق في العلوم التجريبية، وظلّ تأثيرها على ما يليها من حياة الناس ضعيفاً). وقد نتفق أو لا نتفق مع محجوب في كون هذا الاختلاف (اختلاف نوع) أو (اختلاف درجة) إلا أن محجوب يواصل طرحه، ويفنّد مرئياته قاصداً بذلك: (تبيان أن ادّعاء البعض بوجود اختلاف جوهري في ماهية البرهان بين العلم وسواه، من كافة اهتمامات الناس في حياتهم وعقائدهم، ادّعاء باطل لا يقوم عليه دليل). إزاء النقلات الكبرى والانقلابات الجذرية التي أحدثها (المنهج العلمي) في حياة البشر، فإن (الانبهار) بالمنهج العلمي أصبح معلماً بارزاً من معالم (الفكر المعاصر)، وهنا يتدخّل محجوب ليؤكّد - مراراً وتكراراً - أن ذلك (الانبهار) يجب أن يخضع للتحليل والمراجعة والتشخيص، وليُـبرز (إنسانية) العمل العلمي وخضوعه لمقاييس البشر وقصورهم، فـيقول: (إنـنا يجب أن ندرك هذه السمة المهمة في الكتابة العلمية: إنها تعكس عقائد فلسفية خفية للباحثين والمؤلفين لا تقتضيها بالضرورة النتائج التجريبية التي يكتبون عنها. مـتى ما أدركنا هذا سهل علينا أن نتابع ما يُكتب وما يُقال بحذر وتدقيق. ومع الزمن يمكن أن يكتسب المرء خبرة كافية تمكّنه من استيعاب المادة العلمية البحتة فيما يقرأه، وأن يتعرّف على فلسفة الكاتب وعقيدته في آن واحد، ومن خلال النص ذاته، دونما أي خلل). تـُرى ما الذي يشغل بال محجوب، ويحتلّ عقله ووجدانه ليجعله يضفي على هذا الطرح مساحة واسعة من التحليل والتفنيد والحجج؟. هل هو خوفه من أن يقوم البعض بدسّ السم في العسل؟. |
|
|
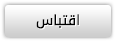
|
|
|
[12] |
|
عضو فضي
 |
4- أكـثر من مرة سألت محجوب عبيد طه – رحمه الله- عن السبب الذي جعله يعزف عن تأليف الكتب يجمع بين دفتيها طروحاته العميقة، ومقالاته الثرية، وسجالاته المنضبطة، ليتلقّفها المهتمون بالفكر المعاصر ودلالاته، والعلاقات المتشابكة بينه وبين فكر الأمة الإسلامية وعقيدتها، ولتسهم تلك المؤلّفات في انتشال مستوى الفكر والثقافة مما هيمن عليه من حالات هزيلة متردّية تجترّ نفسها، وتغوص في استنساخ الذات فلا تقدّم جديداً، ولا تحلّ إشكالاً، ولا تطوّر واقعاً. وفي كلّ مرة كان يتفادى - بأدب جم - الإجابة على سؤالي الملح حتى إذا ما فاض الكيل انصرف وهو يضرب بيده على كتفي مازحاً بطريقته المميزة وهو يقول: (يـازول!). كنت أعلم في قرارة نفسي أن أعداء محجوب هم تواضعه المفرط، وزهده الصادق في الشهرة، ومقته الغريزي للأضواء، فكان يتحاشى أيّ مسلك قد يقود إلى تلك الأجواء، وكان يعطي عطاءً متدفقاً في عالم التدريس والبحث والفكر ضمن الضوابط التي وضعها لنفسه، ووفق المعايير التي اختارها لحياته، ليكون كل ذلك خالصاً لوجه الله لا يهدّده شبح رياء، أو يتسلّل إليها طيف شهرة. ذلك هو محجوب (الإنسان)...أمـا عطاؤه الفكري الأصيل فهو في حاجة إلى من يجمعه وينقحه ويراجعه وينشره ليكون إضافة متميزة على ساحة (الفكر العربي) التي تشحّ فيها – بشكل مدقع - الطروحات العلمية المتميزة، واللمحات النابهة المرتبطة بمعطيات العصر ومتغيراته، وهذا ما حاولت القيام ببعضه مجموعة صغيرة من محبي محجوب، من بين أعضائها صاحب هذه السطور، ولعله من المؤسف أن جهد هذه المجموعة وإمكاناتها لم تسمح لها حتى الآن بتحقيق ما تصبو إليه. لقد وجدنا في المقالات السابقة أن أحد المسارات الفكرية التي اهتم بها محجوب هـو بلورة الأسـس التي يستند إليها (المنهج العلمي-التجريبي) الذي يميّـز العلوم الطبيعية، وحرصه على توكيد (الجانب الذاتي) للمنهج حيث تتجلّى قناعات الباحث الشخصية، ومنطلقاته الفلسفية والعقدية ضمن (الصورة الموضوعية) التي يتباهى بها (المنهج العلمي). لم يكن ذلك الاهتمام يكمن فقط في الجانب الفلسفي والفكري للقضية، وهو جانب مهم، ولكنه أيضاً كان يتأسّس على فهم عميق لطبيعة الاشتباك الحاصل بين (المنهج العلمي) و(العقائد الكونية) و(الممارسات الحياتية)، وكيفية إنزال ذلك الاشتباك، وتشخيص طبيعته، وتمحيص آثاره على التفاعلات الفكرية والعقدية والحياتية للأمة الإسلامية. لقد كان محجوب – رحمه الله -، من واقع اهتمامه بخصائص وطبيعة هذا المنهج وطريقة صياغة (القوانين الطبيعية)، يتصدّى إلى قضيتين جوهريتين: الأولى: تحديد حقيقة الأثر الذي يحدثه الباحث عبر قناعاته الشخصية، وعقيدته الخاصة، ورؤاه الذاتية، في تناوله للقضايا العلمية التي يعتقد غالبية الناس بأنها تسنّمت قمة (الموضوعية التجريبية) و(المنطق الرياضي)، ولا مكان فيها لتحيزات المتحيزين وتخرّصاتهم. أمـا القضية الثانية التي حاصرها محجوب وعالجها بعنفوان فهي إبراز (الحيل العلمية) التي يتحايل بها بعض العلماء في الغرب من أصحاب التوجّهات الإلحادية لتكريس عقائدهم الخاصة، وجعْلها تبدو وكأنها جزء لا يتجزأ من (العلم الطبيعي)، ومن أمثال هؤلاء الفيزيائي البريطاني الشهير (ستيفن هوكنج)، والفيزيائي الأسترالي (بول دافيز) وغيرهما. عند إنزال القضيتين على الواقع الإسلامي، فإنهما يلتقيان - في رأيي- عند مصطلح (أسلمة العلوم الطبيعية)، وهذا مصطلح له مؤيدوه وله معارضوه، وقد لا نستغرب وجود معارضين في ضوء (الانبهار) السائد والقول الشائع عن (حيادية) و(موضوعية) العلوم الطبيعية، إلا أنه قد يصبح من الصعب علينا فهم وجود من يعارض (أسـلمة المـعرفة) في جوانبها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكلٍ عام. أقول...تلتقي القضيتان – في رأيي – أمام مصطلح (الأسلمة) لأنني في الواقع، طوال حواراتي الطويلة مع محجوب وقراءتي واستماعي لطروحاته، لم أجده يستخدم مصطلح (الأسلمة)، إلا أننا نجد،عند تحليل فكره واهتماماته العقدية والفلسفية، أنه كان يدفع بشكل حثيث في ذلك الاتجاه عبر تحليل دقيق، وتشخيص منهجي. كـأني بمحجوب كعادته يربـأ بنفسه عن الدخول في صـراعات كلامية ومهاترات لا طائل فكري من ورائها، فهو يهتم فقط بالغوص في الجوهر، وإجلاء الحقيقة، وإعمال العقل الناضج في قضايا الفكر العميقة، وكأنه يقول...استنتجوا بعد ذلك ما شئتم من مفردات، وسكّوا ما شئتم من مصطلحات. يحتجّ بعضهم في معارضته لمبدأ (أسلمة العلوم الطبيعية) بأنّ (العلم محايد ولا وطن له)، ومحجوب لا يتطرّق إلى هذه المقولة الشائعة، ولكنه يغوص في أعماق (الفكر العلمي)، ويقرّر حقائقه، فيقول: (إن الباحث لا يُـقبل على عمله خالياً من الأحاسيس والمحتوى الفكري، وإنما يقبل عليه بطموح وتصوّر وتوقّع في إطار فلسفة عقدية أصبحت من خصائص كيانه وشخصيته). ولكن ما قولك يا محجوب في حياد وموضوعية (المنهج العلمي)؟، ويأتي الرد سريعاً ليقول: (الحق أن الموضوعية المهنية المطلوبة في البحث العلمي هي موضوعية رصد الحقائق والمشاهدات كما وردت، وليس هناك إلزام مهني بـحصر التأملات والاستنتاجات والعبارات بحيث لا تتعدّى هيكل الحقائق المجردة. ولقد ذكرنا أن مثل هذا الالتزام لا يفيد العلم شيئاً. غير أن الأمر قد يُـبالغ فيه من الطرف الآخر فتُـقدّم نظرة فلسفية مثيرة في إطار لا يحوي علماً مفيداً. في مثل هذه الحالات يستغلّ العالم رصيد سمعته العلمية ليبلّغ رسالة لا تتصل بعلمه وتخصّصه وإن سربلها بسرابيل علمه وتخصصه). ويطلق محجوب تحذيراً هاماً لكل من يتعامل مع (العلم الطبيعي)، أو يقفز على نتائجه العملية إلى أبعاد فلسفية أو عقدية أو فكرية، فـيقول: (وأخـتم بالتركيز على النقطة الأساسية في هذه المقالة، وهي التأكيد بأن المجهود المبذول نحو تحصيل العلوم الطبيعية، منذ التخطيط الأوّلـي لإجراء التجارب المعملية حتى صياغة القوانين العامة والنظريات الأساسية هو مجهود بشري عليه سمات العاملين عليه، وبصفة خاصة يعكس بوضوح مواقف عقدية وإضافات فكرية وظلالاً فلسفية ليست ضرورية لاستيعابه ورعايته وتطويره. ومن المهم أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند الاطلاع على الكتابات العلمية، وعند تدريب الناشئة في مجالات العلوم الطبيعية كافة). إذا لم تكن تلك دعوة واضحة إلى الاهتمام بأسلمة العلوم الطبيعية، فإنها - على أقل تقدير - دعوة إلى التصدّي إلى ما يحاول البعض إسباغه على (العلوم الطبيعية) من قناعاتهم الفردية، ومنطلقاتهم العقدية. |
|
|
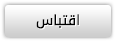
|
|
|
[13] |
|
عضو فضي
 |
5- عندما قام أستاذنا الفاضل الدكتور راشد المبارك بتكريم ذكرى محجوب مرتين في أحديته المتألقة في دارته العامرة بالرياض، فإنه كان – جزاه الله خيراً - يسجّل لحظات شموخ واعتزاز، ويضع بصمات وفاء وتقدير لرجل اجتمعت فيه صفات مميزة فهو محجوب (الإنسان)، و(المفكر)، و(العالم). ولذا استمتع الحضور في الندوتين، من يعرف محجوب منهم ومن لا يعرفه، برحلة ثرية تمحورت حول أبعاد هذا الرجل المتسامقة التي كان كثير منها خافياً، وحتى أولئك الذين أحبوه وزاملوه سنوات طويلة، ومنهم صاحب هذه السطور، اكتشفوا جوانب في شخصية الرجل لم يكن لهم بها علم، فقد كان رحمه الله زاهداً في الأضواء والشهرة واستعراض الذات، ومعنياً فقط بما يقدّمه - في هدوء وتمكّن - على الأصعدة الفكرية والإنسانية والعلمية. لقد عمل الفيزيائي الفذ والمفكر المرموق البروفسور محجوب عبيد طه في جامعة الملك سعود لما يربو على العشرين عاماً، ولم يتوقف فيها عطاؤه قط حتى في سنواته الأخيرة إبان صراعه مع المرض، فهو قد أحب هذا البلد، وأحب أهل هذا البلد، ولذا لم تغره عروض من أصقاع شتى يسيل لها لعاب الكثيرين، وآثر أن يبقى حيث اختار بقناعة كاملة، مكرّساً حياته للعلم الفيزيائي، والفكر المتألّق، والقدوة الصالحة. قلنا فيما سبق إن محجوب حرص على إبراز (إنسانية) العلم الطبيعي، وتأثره بقناعات الباحث وعقيدته فيما يضفي عليه من ترجمات لمعطياته، وتأويل لقوانينه بحيث يحسب الناس أن تلك التصورات امتداد حقيقي لموضوعية (العلم الطبيعي) ومنهجه الحيادي. مثل تلك التأويلات يمكن أن تصبّ في عدّة اتجاهات، وتحمل عدداً كبيراً من الدلالات، ولذا حرص محجوب - بشكل عام - على التحذير منها، والاهتمام بفحصها فحصاً منضبطاً ومـنطقياً لـيصبح ذلك – فـي نظره – أحـد الأوجـه الضرورية للتعامل الفلسفي والمعالجة الفكرية لنتائج (العلم الطبيعي) ومعطياته. أمـا القضية الثانية التي اهتم بها محجوب، فهي قضية التصدي للمحاولات المتكررة من قبل بعض العلماء الطبيعيين في الغرب لإضفاء الصبغة الإلحادية على (العلم الطبيعي) في تفسير وجود الكون، وتعليل غاياته. ذلك الرجل النحيل، الذي كان يقطر أدباً وحياءً وتواضعاً، كان يتحوّل إلى عملاق فكري شامخ وهو يتصدّى لملاحدة هذا الزمن من علماء الطبيعة الذين سبقتهم شهرتهم العلمية ليدسّوا (السم في العسل)، وليغلّفوا رؤاهم الإلحادية بغلاف (العلم الطبيعي)، وهو من ذلك براء. يقول محجوب – رحمه الله -: ( وبتطوّر مفاهيم العلم الطبيعي ونظرياته، وبعد النجاح الباهر لتطبيقاته التقنية، تغيرت ملامح الحياة الاجتماعية، وتعقّدت العلاقات بين الأجيال، فظهرت الثورات على (المسلّمات)، ومنها المسلّمات في العادات والأخلاق والدين، وجاءت فترة أصبح فيها الإلحاد عند الشباب (تقليعة)...لا ترتكز على علم أو فلسفة أو تأمل. وبمرور الأيام غزا بعض هؤلاء عالم الفكر والعلم الطبيعي، ومنهم من برع فيه واشتهر، ففكّر وقدّر وصوّر للناس أن العلم الطبيعي صنو الإلحاد وداعيته، وأن التمسّك بالعقيدة الإلهية من سمات الجاهلية الذين لا يواكبون تطورات العلم الحديث وفتوحاته). ويواصل محجوب طرحه فيقول: (نجد اليوم عدداً من ملاحدة علماء الطبيعة قدّموا تصورات لنشأة الكون، وظهور المادة والحياة، يُستفاد منها ظنّهم أن فرضية وجود الله لا تخدم غرضاً مفيداً للإنسان المعاصر، وأن الفكر المبني على العلم الطبيعي ونظرياته يمكن أن يحلّ محلّ الدين في النظر لبدايات الوجود ونهاياته، وفي مقاصد سننه وقوانينه. هؤلاء فئة آمنت بالعلم الطبيعي وبمقدرات الفكر الإنساني، فخرجت به عن نطاقه المحدود، لتهتدي به في المرامي البعيدة بعد أن أعمته بالظن والهوى، فأضلها الله على علم). ينخرط محجوب في دقة علمية ليفنّد مقولات الملاحدة فيقول: (كلّ من قرأت لهم من العلماء الملحدين دون استثناء يعتقدون أن أساس الإيمان بالله حاجة الناس لتفسير ظواهر لا تفسير لها، ظواهر (أراد) الله حدوثها ولا نعلم لها سبباً سوى ذلك. معنى ذلك أن الأشياء التي تحدث حدوثاً طبيعياً (أي لها ارتباط سبـبي معلوم) لا تتطلّب وجود الله في ظنهم، ويدّعون أننا نقول بأن الله خلق الحياة إذا كنا نجهل تفسيراً علمياً لأصل الحياة، ولكن إذا صحّت لدينا نظرية علمية في أصل الحياة وقبلناها، فقد انتفت الحاجة للقول بأن الله خلق الحياة، وعلى المؤمنين البحث عن ظاهرة أخرى يعلّقون عليها علّة لإيمانهم. مثل هذا الظن السقيم لا يخلو منه كتاب مما وقع في يدي من الكتب المعاصرة عن الفكر المترتّب على العلم الطبيعي وصلته بالعقيدة الدينية (هوكنج، واينبيرج، ديفيز، ديكنز وغيرهم). وهذا أمر غريب لأن العقيدة الإيمانية واضحة وميسورة، وليس من عذر عند هؤلاء المفكرين لخطأهم أو جهلهم بها). ويوضح محجوب أبعاد تلك (العقيدة الإيمانية) فيقول: ( جوهر العقيدة الإيمانية أن للوجود خالقاً، خلق الزمان والمكان والموجودات، وخلق القوانين التي تتفاعل بها هذه الموجودات، وتتطوّر في الزمان والمكان. كلّ ما يحدث يحدث وفق سننه، ويحقق مقتضى إرادته وتقديره. وما نراه ونحسّه من الموجودات أنما هو الشيء اليسير الذي هيّـأ الخالق لنا إمكانية الوقوف عليه، وفيه دليل على عظمة الخلق والخالق، وعلى بديع صنعه وتقديره فيما لا يمكن أن نحيط به من كلّ صغيرة وكبيرة في هذا الكون الشاسع). يواصل محجوب تفنيده لحجج الملاحدة فيقول: (الذي يبني على الظن السقيم بأن الظواهر التي تحدث بسبب معلوم لا تتطلّب الاعتقاد بوجود الله يحسب أن الدين هو الإيمان بالخوارق، والواقع أن الدين عكس ذلك تماماً، فالمؤمن يعتقد أن كلّ ما يحدث يحدث بسبب طبيعي، أي وفق سنن الله وتقديره. وكما أن معرفة السبب في الظاهرة البسيطة لا تنفي مشيئة الله وتقديره، فإن مـعرفة السبب في الظاهرة المعقّدة لا تنفيها. لدينا نظرية واضحة في كيفية هطول المطر وهي لم تمنعنا من الاعتقاد بأن الله أنـزله، فلـماذا تمنعنا نـظرية (غير واضحة) في كيفية بدء الحياة من الاعتقاد بأن الله أنشأها؟). وهنا يُـبرز محجوب دور (العلم الطبيعي) وحدوده فيقول: (إن معرفة الكيفية التي تحدث بها الظواهر هي كلّ ما نستطيع أن نحصّله من العلم الطبيعي، وهذا ما أمرنا الله به حتى في حالة بداية الخليقة: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير) (العنكبوت: 20). إن معرفة الكيفية هي اكتشاف القانون الطبيعي الذي بموجبه حدث الحدث، أو نشأت الظاهرة، أي التعرّف على سنة الله فيما يتعلّق بهذه الظاهرة، وهذه هي مهمة العلم الطبيعي الأساسي). |
|
|
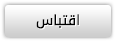
|
|
|
[14] |
|
عضو فضي
 |
6- في ذلك اليوم الحزين من صيف عام 1421هـ، الذي وارينا فيه محجوب الثرى، رحت أتجوّل بنظري بين الحشد الذي اجتمع للوداع الأخير في مقبرة النسيم في الرياض، وكما عاش الرجل في هدوء ورقة يتحاشى الأضواء والشهرة، فإنه رحل في هدوء وسكينة ليترك وراءه ينبوعاً من العطاء، وكنزاً من الحب، وثروة من التقدير. تذكرّت ساعتها مقولة برنارد شو: (العربة الفارغة أكثر جلبة من العربة الممتلئة، وكذلك أدمغة الناس)، ففي زمن يبحث فيه كل من هبّ ودبّ عن الأضواء والشهرة، ويفعلون الأعاجيب والألاعيب ليكونوا (في الصورة)، كان محجوب، بعطائه الأصيل وفكره المتوقد، ينأى بنفسه عن أي مسلك قد يقوده إلى تلك الأضواء، أو يلقي عليه شيئاً من الهالة. لقد أوجز لي أخي الكريم الدكتور عادل حسيب، وهو الذي درس على محجوب في جامعة الخرطوم ثم زامله قرابة العشرين عاماً في جامعة الملك سعود، أقول...أوجز لي موقف محجوب من الحياة والناس في جملة موفّقة عندما قال: (لقد كان محجوب يريد فقط أن يكون واحداً من الناس له مشاركاته ضمن مشاركات الجميع فلا يميزه عن غيره من الناس شيء، ويرفض بشدّة أن تكون له صورة خاصّة تضع له قدراً من الأفضلية على غيره من الناس). كان محجوب أحد الأفذاذ القلائل في العالم العربي القادرين على المزاوجة بين طوفان (الحركة العلمية) المعاصرة وفكرها ودلالاتها، وبين التراث الإسلامي في أصوله الصحيحة، ومناهله النقية، واجتهاداته الأصيلة، لتبرز رؤية (إيمانية – علمية) راقية تتصدّى بعنفوان لتخرّصات الملاحدة، وطغيان المادية، وحذلقة أنصاف العلماء. لقد رأينا في الأسابيع الماضية كيف كان محجوب يحاكم (المنهج العلمي – التجريبي) من الداخل، ويتصدّى لطروحات منمّقة يطرحها روّاد فـي (العلم الطبيعي) وهم يستغلّون شهرتهم العالمية، وإنجازاتهم العلمية، لإضفاء قناعاتهم الذاتية على (العلم الطبيعي)، ومن ذلك إبراز (الفكر الإلحادي) وكأنه نتيجة تلقائية لمعطيات (الفيزياء) ومبادئها، ومن أمثلة أولئك الفيزيائي البريطاني المشهور (ستيفن هوكنج). لم يكن محجوب، وهو يقارعهم بالدليل والحجة، غريباً على (المنهج العلمي)، ولم يكن طارئاً على (العلوم الطبيعية)، ولكنه كان ابن بجدتها، وله إسهاماته المميزة في مجال من أكثر مجالاتها صعوبة...وأشدّها تعقيداً، ولذا فإنه كان يتحدّث بطلاقة المتمكّن، واستئناس العارف ببواطن الأمور. لقد كان – رحمه الله – يتعقّب حججهم واحدة واحدة، وهم يحاولون تأسيسها على مبادئ (الفيزياء) وقوانينها، وكان يدحض افتراءاتهم دحض مفكّر عالم يدرك خفايا اللعبة التي يريدون أن يلعبوها، ويمسك بزمام الآليات التي يريدون أن يستغلّوها. ولعلّه من المناسب هنا أن أتوقف أمام رؤوس أقلام دفع بها إليّ محجوب بخطّ يده الأنيق لمحاضرة ألقاها في عام 1419 هـ في (كلية العلوم) بجامعة الملك سعود، وهي بعنوان (العلم والدين). يبدأ محجوب محاضرته بطرح السؤال: (ما هو العلم وما هو الدين؟)، ويجيب فيقول: (جوهر العلم هو معرفة كيفية حدوث الظواهر، ومهمة العلماء البحث عن القوانين التي تحكم هذه الظواهر وتطوير سبل الاستفادة منها. أمـا جوهر الدين فهو توضيح حقيقة الوجود، ومهمة الرسل تبليغ هذه الرسالة وتقديم تصوّر شامل للوجود ومكان الإنسان فيه. وهكذا فإن العلم مجهود بشري بينما الدين وحي سماوي، وبينهما تداخل). وينطلق محجوب ليبرز طبيعة (التداخل) بين (العلم) و(الدين) فيقول: (هناك تداخل مباشر فقد جاء في الوحي آيات عن بعض الظواهر الكونية وخصائص المخلوقات، ويمكن إدراك اتفاقها مع الـمُـشاهَد بوسائل العلم الطبيعي، وهذا تداخل محدود. أما التداخل الأشمل فهو أن العلم جزء من الدين، فالأمر بتأمّل أحوال المخلوقات والتفـكّر في الظواهر الكونية مما جاء به الوحي تكليفاً على بني الإنسان، وهذا يشمل كلّ العلم الطبيعي ولا يستثني منه شيئاً). ويواصل محجوب طرحه ليبرز (العلم) من منظور (الدين)، فيقول  الاعتقاد بوجود خالق مدبر يقتضي الاعتقاد بأن ما يكشفه العلم من خصائص وقوانين هو كشف عن بعض سنن الله في الخلق، ولا توجد حقائق أو قوانين علمية لا تندرج تحت هذه المظلة). الاعتقاد بوجود خالق مدبر يقتضي الاعتقاد بأن ما يكشفه العلم من خصائص وقوانين هو كشف عن بعض سنن الله في الخلق، ولا توجد حقائق أو قوانين علمية لا تندرج تحت هذه المظلة).أمـا (الدين) من منظور (العلم) فإن محجوب يضعه في الإطار التالي: (إن مبحث العلم الطبيعي محدود بحدود بيئة الإنسان مما يوجب تصوّراً شمولياً للوجود يكون أوسع من مدارك العلم، وبالتالي فإن العلم لا يستطيع أن يثبت أو ينفي صحة هذا التصوّر). استناداً إلى ما سبق فإن محجوب يخلص إلى نتيجة هامة وهي: (أن المؤمن الذي يهاجم العلم يصدر عن جهله وليس عن عقيدته، والعالم الذي يهاجم الدين يصدر عن ظنّـه وليس عن علمه). ويعرّج محجوب على أحد مزاعم الملاحدة عندما يقابلون العلم بالدين على أساس أن كلاًّ منهما يقصي الآخر، فيقول بعضهم: (ما تعلّمناه من العلم الطبيعي عن هذا العالم خلال القرن الحالي أكثر مما علّمتنا إياه الأديان خلال القرون السابقة، وبالتالي فإن العلم الطبيعي يكفي). يقول محجوب: (إن ذلك الزعم قد يصحّ عند بعض الناس، ومنهم من استغنى عن العلم والدين معاً، ولكن هذا ليس صحيحاً عند كثير من الناس، وذلك لحالتين واضحتين، وهما متطلّبات الحياة العادية، وإشباع طموح المعرفة العميقة). فيما يتعلّق بمتطلّبات الحياة فإن: (ثوابت العلم الطبيعي لا تكفي هَدْياً في حياة الناس، فنحن لا نستطيع أن نثبت علمياً أن التضحية في سبيل فكرة عمل مجيد، أو أن ملازمة الأم المريضة سنوات عديدة أفضل من الانصراف عنها). وأمـا فيما يتعلّق بسبر غور (حقيقة الوجود)، فإن محجوب يوضح أن العلم عاجز، لأن تلك الحقيقة تقع خارج نطاق العلم البشري، ويقول: (هـناك ثلاثة أسئلة أساسـية تهمّ الإنسان، ولا يجيب عليها الـعلم الطبيعي، وأوّل الأسئلة هـو أن العالم الـمُـشاهَد عبارة عن قدر كبير من الطاقة، فمن أين أتت هذه الطاقة؟). أمـا السؤال الثاني: (تتفاعل الموجودات في العالم المـُشاهَد وفق قوانين محدّدة، تمكّن الإنسان من معرفة العديد منها، فمن أين أتت هذه القوانين؟). وأما السؤال الثالث: (نتيجة هذه التفاعلات بين الموجودات يتطوّر العالم الـمُـشاهَد باضطراد، وتتغير أحواله، فما الغاية التي تستهدفها هذه المسيرة؟). ويخلص محجوب، بعد طرح تلك الأسئلة التي يقف (العلم) عاجزاً أمامها، إلى أن: (الدين أعطى بسطاء الناس تصوّراً عميقاً للوجود، تفوّقوا به على كافة الملاحدة مهما عظم حظّهم من العلم الطبيعي). رحم الله محجوب فقد كان مؤهلاً علماً وخلقاً وفكراً وإيماناً لطرح رؤية خصبة تسهم في انتشال الأمة من واقعها الحزين، وتدفع بها نحو مواقع متقدّمة على طريق الإنجاز العلمي، والفكر الناضج، والتأثير الفاعل على (الآخر). ولذا عندما نرثي فقده، ونستشعر غيابه، فإننا ندرك أن مثله في الأمة قليل ونادر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. |
|
|
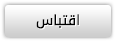
|
|
|
[15] |
|
عضو فضي
 |
اعتذر عن اطالة الموضوع ولكن هذا الرجل يستحق ان يعرفه كل مسلم
وكما اشكر الاستاذ عادل الرحيلي على مروره والشكر لنهر الامل وكذا للعضو الموقوف |
|
|
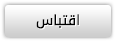
|
|
|
[16] |
  |
[align=center]
جزاك الله خيراً الله يعطيك العافية رحمه الله وغفر له ذنوبه وادخله فسيح جناته إن شاء الله أخي سارب الأمل لا تعتذر عن الإطالة فكما قلت يستحق منا الكثير فمن خدم العلم يستحق الإشادة والدعاء له [/align] |
|
|
|
|
|
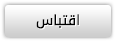
|
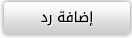 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
مدينة, عتدي  |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|